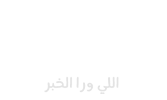واحد اتنين سَرجي مَرجى إنت حكيم ولا تمرجى .. ذكريات فوق الستين
إذا كنت قد غنيت فى الحارة مع أصحابك الولاد والبنات اغانى من عينة " يا ابو الريش يارب تعيش " و احد اتنين سرحى مرحى انت حكيم ولا تمرجى " وفى رمضان غنيت ايضا مع العيال حالو ياحالو رمضان كريم ياحلو وفك الكيس وادينا بقشيش " فاأنت من جيل تعدى الخمسين عاما بسهولة شديدة وربما أكبر بعدة سنوات ، حيث لم يكن الفيس بوك ولا الكاسيت حتى قط ظهرا ، وكانت الاحتفالات " لايف " فى الخارة والشارع ، والاغانى الشعبية تتوارثها الأجيال جيل وراء جيل ، ولم نسال أبطأ عن معنى حلو ياحلو ولا سرحى مرجى ولامعنى " تيك تراك " اللعبة الاولى للولاد اضافة الى البلي والكورة الشراب وهى وكرة تصنع من الإسفنج الذى يكور داخل شراب قديم ويلف بالخيوط ثم تغطى بالكلة !
عودة الى الاغانى الشعبية او اغانى الشارع والحارة ، .تحكى " وئام مختار "ولاحظ ان اسم وئام ايضا من الأسماء العربية النادرة ، ووئام يعنى توافق وانسجام ، ويبدو ان وئام واحدة من جيلنا عاشت حكايات تلك الاغانى وروتها على موقع مجلة منشور، ارجو ان تستمتعوا بالحكايات كما استمتعت انا بها .
تبدأ الحكاية من عند الجدة، القادمة من صعيد مصر إلى قلب القاهرة لتعمِّر بيتًا كبيرًا في قلب حي السيدة زينب. كبر أولادها وتزوجوا، وبدأ الأحفاد في التوافد والإقامة معها أغلب أيام الأسبوع. كانت تغني لهم، تعمل في المنزل طوال النهار وتغني لهم وهم يتحلقون حولها، منذ الاستيقاظ صباحًا حتى الهدهدة والنوم. هناك أغنية لكل مهمة يؤدونها، كالتراث الشعبي الذي يحفظ للإنسان دورة حياته من المهد إلى اللحد، ويسجل أحزانه وأفراحه.
كانت الجدة تؤدي هذه المهمة بشكل غنائي، فتجد للاستيقاظ أغنية، ولتناول الطعام أغنية، وللنوم أغنية، وللتهنين واللعب أغنية، ولتبديل الأسنان أغنية، وهكذا.
«لمَّا قالوا دي بنيَّة»
الصورة: Statens Museum for Kunst
.
تحكي أمي من ذكرياتها أنه كان لكل نشاط يومي أغنية، وللولد أغنية وللبنت أغنية، وكانت الجدة لا تمل من تكرار الأغاني كل يوم بنفس الترتيب، حتى أصبح الأولاد أكبر قليلًا، وبدؤوا يشاركونها الغناء.
بالطبع كان للأولاد حظوَة لدى الجدة، «لمَّا قالوا ده ولد، انشد ضهري وانسند» و«لمَّا قالوا دي بنيَّة، الحيطان مالت عليَّا والأغنية طبعا تشكل انحيازا للأولاد الذكور وعدم ترحيب بالإناث
.
«لمَّا قالوا دي بنته
بات عشانا ما كلناه
واللي اتعشى نفد بعشَاه
وأبوها اتكلفِت بغطاه»
فيما كانت تغني لكل ولد يجلس لأول مرة في حجرها الدافئ:
وتستزيد في الفرح بقدومه:
«لما قالوا ده ولد
انشَد ضهري وانسند
وجابوا لي البيض مقشَّر
وعليه سمن البلد»
وفي الخروج الأول من المنزل إلى السوق القريبة كانت تغني في الطريق:
«مين نضَرُه مشرَّق ومغرَّب
والشمس تِقدَح في جبينه
وبنات الهوى تقول
يا ريتنا من حريمه»
كان هذا إسهامًا مباشرًا من الجدة في تأسيس أفضلية الذكور على الإناث في جيل العائلة الأول الذي ينمو ويترعرع في القاهرة، ناقلةً إليهم ثقافة الصعيد، بدايةً من الاهتمام بصحة وغذاء الأم التي أنجبت الولد، الذي سيكون معينًا وسندًا في الحياة الصعبة، وحتى شبابه، الذي ستتعارك النساء للحصول عليه..
قُرب نهاية ثمانينيات القرن الماضي وُلدت أنا، البنت الوسطى في عائلة صعيدية قاهرية، تعيش في السعودية. في ذلك الوقت، لم تكن هناك وسائل لعب وترفيه للمواليد بالتأكيد، فبدأت أمي في غربتها تغني لي منذ الولادة:
«لمَّا قالوا دي بنيَّة
قلت الحبيبة جايَّة
تعجني لي وتخبز لي
وتسخَّن لي الميَّه»
بدأت الانحيازات تتغير قليلًا في ذلك الوقت، توقفت جدتي عن التغنِّي بميل الحيطان، وبدأت ترضى عن البنات، ولم لا، فكل بناتها تعلمن ويعملن وتزوجن وأنجبن، مثلهن مثل الذكور تمامًا.
أمي، آخر العنقود، سمعتْ هذه الأغنية منها ونقلتها إلى سريري في الغُربة، وبالعكس، بدأ يخرج من الصعيد بعض الأغاني التي تتخوَّف من إنجاب الولد، مخافة أن تسرقه الزوجة الصبية، مثل:
«ما تفرحيش يامُّ الولد
البنت كبرت عِشقته
يبني لها بيت قبلي البلد
تحرم عليكي حِجِّته»
في تخوُّف واضح من الدخول في منافسة مع المرأة التي ستمنحه نفسها وتنجب له الذكور أيضًا.
«حلقاتك.. بِرجالاتك»»
بالطبع، لم تتحمل أمي فكرة أن تلدني في السعودية على مبعدة من الأهل والأقارب. كانت ولادتي هنا في مصر، و«السبوع» أيضًا هنا، وفي بيت الجدة بدأت «تدق الهون» وأنا محمولة في الغربال، في صورة عائلية شهيرة، والأغنية الجماعية تتردد في الخلفية:
«حلقاتك برجالاتك، حلقة دهب فى وداناتك
يا ربنا يا ربنا، تكبر وتبقى قدِّنا»
بينما يثقبون أذني كي أرتدي بعد ذلك «الحلق الذهب»، علامة الأنوثة الشرقية، واضعين مكانه مؤقتًا خيطًا من حرير حتى يلتئم الجرح بسلام.
«خُد البزَّة واسكُت»
لم تطل الإقامة في القاهرة، عدنا إلى الغربة مرةً أخرى، هذه المرة بطفلة صغيرة. تحاول الأم أن ترعى أموري، بينما الأخ الأكبر في مرحلة تعلُّم القراءة والعد. أخذتْ شيئًا من القاهرة يعينها على الصمود، ويشجعني على النوم:
«خُد البِزَّة واسكُت، خُد البِزَّة ونام
وأمك السيدة، وأبوك الإمام»
ثم تنتقل إلى الدعاء والابتهال والتضحية بمؤونة البيت حين أرفض النوم:
«يا رب ينام يا رب ينام، وأدبحله جوزين حمام
ياكل ويقول كمان
ما تخافشي يا حمام، باضحك عليه لمَّا ينام»
كان لدى جدتي بالطبع «صندرة» (مساحة علوية فوق المنزل) لتربية الطيور والدواجن، وربما بعض الأرانب، وكانت الأم متشبعة بتراث الجدة مهما اختلفت المساحات الحديثة.
يقول الدكتور محمد شبانة، الأستاذ بالمعهد العالي للفنون الشعبية في أكاديمية الفنون، إن الأغاني الشعبية مرآة للثقافة، تحمل في طيات نصوصها الاتجاهات الراسخة والمعبرة عن رؤى المجتمع التي تصدر عنه، وعاداته وتقاليده، والنموذج المثالي الذي يتطلع إليه هذا المجتمع في مناحي الحياة كافة.
من ضمنها، هذا الحب والتواصل الصافي مع آل البيت، الذي انتقل عبر الأجيال من أغانٍ كثيرة مشابهة....
«صباح الخير وصبَّحنا»
تحكي أمي أنها كانت تحاول خلق بيئة مصرية في الغُربة، التي بدا بعد سنة وأخرى أنها ستمتد قليلًا، فكانت الأغاني التي حفظتْها من أمها وسيلة «الدلع» والتواصل معنا، فنستيقظ على:
«صباح الخير وصبَّحنا
رُز بلبن وطبخنا
يا رب يزيد العُمر يطول
وحبيب قلبي يفضل ويَّايا على طول»
توضح الباحثة يسرية مصطفى، وهي من رواد الجمع الميداني لأغاني التراث من الخمسينيات حتى السبعينيات، في دراستها عن «المرأة وأغاني تهنين الطفل»: «أغاني المهد تُسهِم في ارتباط الطفل بالتراث، إذ تحمل في طياتها أفكارًا ومعاني ومعتقدات المجتمع الذي أبدعها ووضع فيها مشاعره وطريقة تعامله مع الصغار، واحترام الكبار، وإيثار الترابط العائلي».
«ليس هذا فحسب، بل إن الأغنية الشعبية التي تؤديها الأم أداة أولًا لتسلية طفلها، وثانيًا وسيلة لتنبيه الطفل إلى ما حوله، ومحاولة التعرف إليه والتواصل مع المحيطين به».
كان لدى أمي الوعي الكافي أن تجعل التربية مصرية خالصة، حتى لا «تشوهنا» الثقافة الخليجية بحسب تعبيرها، فقد كان الأب يعمل أغلب اليوم، ونحن نقضي الوقت معها في انتظار عودته، فنغني معًا:
«بابا جاي إمتى؟
جاي الساعة ستة
راكب ولا ماشي؟
راكب بسكلتَّة
بيضا ولا حمرا؟
بيضا زي القشطة
وسَّعوله السِّكة، واضربوله سلام
العساكر ورا، والضباط قُدَّام»
بعدها نشعر أنه لم يغب كثيرًا إلى هذا الحد، وتصبح لحظة دخوله من الباب فرحًا عائليًّا صغيرًا، قائمًا على تواصل مع فكرة وجوده طوال اليوم.
تقول أمي: «الأغاني كسرت الغُربة، وأوصلتكم بمصر، فصارت خلفيتكم الثقافية مصرية، وحين عدتم لم يكن هنالك فارق كبير بينكم وبين أطفال العائلة المقيمين، وأسهم هذا في التأقلم والاندماج في الحياة المصرية بسهولة».
«يابو الريش، إن شالله تعيش»
نشأنا مرتبطين بالجدة، وبالبيت الكبير، رغم البُعد والسفر الذي يجعل إجازتنا السنوية لا تكفي لأي شيء. لا زلنا نتذكر كأحفاد أغنية الرُّقيَة التي كانت تبخِّرنا عليها، أو تكتفي بهز حِجرها وهي تقول:
«يابو الريش، إن شالله تعيش
وتكبر لامَّك
وتبقى عريس
يابو الريش، إن شالله تعيش
وإن عشت لبكره
هاتُبقى عريس»
بحسب «الموسوعة المصرية لأغنيات الطفل» لمسعود شومان، فهذا النص الغنائي جزء من طقس شعبي قديم، يركب فيه الطفل الذي يُخشى موته، أو مات أشقاؤه، فوق حصان أو حمار ووجهه في الاتجاه العكسي، ويوضع فوق رأسه إكليل من ريش الطيور، ويُزف باتجاه المكان الذي سيوشم فيه. والوشم يكون عادةً دقٌّ أخضر في جبهته أو فوق صدغيه. والجدة، التي مات لها «ثلاثة بطون» قبلًا، كانت تحفظ هذه الأغنية جيدًا.، فالأم أصبحت امتدادًا للجدة التي تغني وتهدهِد، وأسهمت كلمات الأغاني في فتح مجال لحب المعرفة، والسؤال عن معاني الكلمات والإشارات فيها، مما فتح بابًا آخر بعد ذلك لإشباع التساؤلات بالقراءة، وجعل التأثر بثقافة أخرى صعبًا، لأننا كنا نحمل مصر داخلنا بالفعل.
«واحد اتنين سرجي مرجي»
لكن شيئًا آخر، بجانب أن معظم الأغاني والحظوة كانت للذكور، كان يتكوَّن بشكل ضمني وبسيط في وسط أغاني الألعاب، فبعد مرحلة «تاتا، خطِّي العتبة» كان لا بد للأغاني أن تكون أطول، وأن تحمل قدرًا لا بأس به من الحركة. تتشارك الأم والجدة في الغناء، أو يحملنا الكبار أمام الآخرين في وضع أفقي، ويحركوننا باعتبارنا أرجوحة صغيرة، على إيقاع:
«واحد اتنين سَرجي مَرجي، إنتا حكيم ولَّا تُمَرجي
أنا حكيم الصحيَّة، العيَّان أدِّيله حقنة، والمسكين أدِّيله لُقمة
بدِّي أزورك يا نبي، ياللي بلادك بعيدة
فيها أحمد وحَميدة، حَميدة جابت ولد، سمته عبد الصمد
مشِّته ع المشَّاية، خطفت راسه الحدَّاية
حد يا حد يا بوز القِرد، إنتا ولد ولا بنت؟
أنا ولد ولابس طربوش»
جاءت هذه الأغنية من زمن بعيد، وحملت معها دينًا آخر في تنوُّع غير موجود في التغريبة الخليجية. بدأت قصتها من الشراكسة حتى وصلت إلى أقباط مصر.
في كتابه «خارج السياق»، يوضح الناقد أحمد مجاهد أن السَّرجي هو السركي، وهي مهنة أدخلها الشراكسة إلى مصر لتسجيل بيانات العاملين في المروج، أي البساتين، فكان العمال يقفون في طابور طويل أمام الإقطاعي الشركسي الذي يقول للخولي: «واحد اتنين»، فيرد عليه الخولي: «سَرجي»، أي تم تسجيلهما في السركي، فيشير له برأسه بالموافقة، فيقول الخولي للعمال على نفس الوزن: «مَرجي»، أي ادخلوا إلى المزرعة للعمل.
استعمل المصريون بعد هذا عبارة «واحد اتنين سَرجي مَرجي» للسخرية من الطوابير الطويلة التي يسجلون فيها بياناتهم، ثم تلقَّفها فقراء الأطفال المسيحيين وأصبحوا يقولونها وهم يأخذون معونات صحية واجتماعية من أدوية وملابس من الكنائس، حين يقفون في طوابير تسجيل طويلة أيضًا.
أكمل الأطفال المسيحيين الأغنية «إنتا حكيم ولا تُمَرجي؟»، على أن كلمة سرجي صارت تشير في تفسيرهم إلى القديس «أبو سِرجة سرجيوس»، ومرجي إلى القديس «ماري جرجس» أو «مارجرجس»، وما يعتقدون أنهما يقدمانه من خدمات علاجية وإنسانية. وعندما اشترك الأطفال المسلمون مع المسيحيين في اللعب والغناء، أضافوا إلى الأغنية مقطعًا جديدًا: «نفسي أزورك يا نبي».
«اللي ما خلِّفش بنات»
ذهبت الجدة، لكنها تركت في نفوس أولادها شيئًا من تفضيل الذكور، قلَّت نسبته مع الأحفاد اللذين كبروا الآن وتزوجوا وأنجبوا، وأصبحت أمي بدورها جدة، تغني لحفيدها وحفيدتها من بنات وأولاد الإخوة والأخوات، لكن الانحيازات تغيرت تمامًا، وأصبحت تعتدُّ بالبنت كما هي، في صورتها، أنثى، غير مضطرة إلى الاسترجال أو التخفي.
يجلسن معًا أمام الموبايل أو التابلت، في منزل قريب من البيت الكبير في حي السيدة زينب، يغنين مع نانسي عجرم: «حلوة الأيام في عينيَّا، علشان خلِّفت بنيَّة، ولا شُفت الأرض اتهدِّت، ولا مالت الحيطة عليَّا»، في عملية تفاعل مع التراث الشعبي لا تنتهي مهما مرت السنوات، ولا تتوقف بتغير الزمن والعادات.